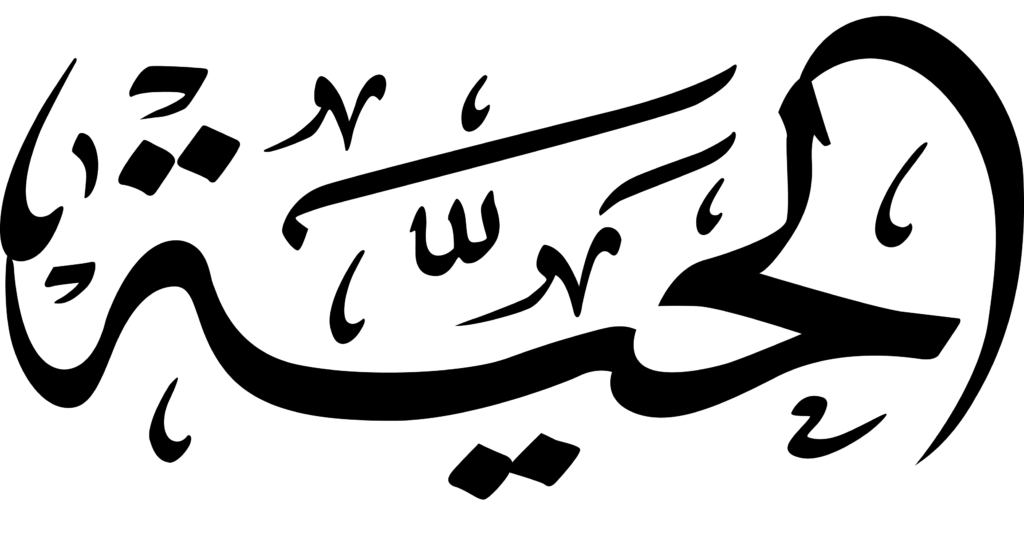كتابة دينا تكروري وعهد التميمي
تصوير تانيا حبجوقة
كتابة دينا تكروري وعهد التميمي
تصوير تانيا حبجوقة
العَوْدَة
مقطع من كتاب عهد التميمي ودانه تكروري. لقبوني بـلبؤة: نضال فتاة فلسطينية من أجل الحرية. عالم واحد (2022).
ترجمة الى العربية: نانسي بشارة

وُلدَ والدُ عَهد التّميمي في عامِ 1967، وهو العامُ الذي بدأَ فيهِ الاحتلالُ الإسرائيليّ للضفّةِ الغربيّةِ، وبالاحتِلال تأثّرَّ كلُّ جانبٍ من جوانبِ حياةِ العائلة. واحدةٌ مِن أقدمِ ذكرياتِ عهد هيَ زيارتُها لوالدِها في السّجن، ودسُ أصابِعها البالغةِ منَ العمرِ ثلاث سنوات من خلالِ السّياج لتَلمسَ يدَه. حتى أن نقاط التفتيش العسكرية المنتشرة في كل مكان والجنود المسلحين وجدوا طريقهم إلى قصص طفولتها الخيالية ولعبها مع أقرانها. لم تداعبها جدتها بأغاني الطفولة، وإنما بحِكم العائلة ومآسيها. وبدلاً من لعبة الشرطة واللصوص، كان هناك جيش وعرب، حيث يلعب الأطفال أدوارهم كجنود إسرائيليين يواجهون مجتمعاً من الفلسطينيين.

في الأسابيع الأخيرة التي سبقت إطلاق سراحي، تقدمت لامتحانات التوجيهي في السجن ونجحت. والدتي، التي كانت أيضاً في الصف التوجيهي، اجتازت امتحاناتها بنجاح. مع أربعة أطفال والآن في أوائل الأربعينيات من عمرها، أكملَت أخيراً تعليمها في المدرسة الثانوية. كانت تشعر بالفخر عندما علمت بنتيجتها، وأنا فاض قلبي بالفرح. أقامت الفتيات في زنزانتي احتفالاً، غنينا أغاني التخرج وصفقنا بينما كنا نتناوب على الرقص. أردنا أن نثبت لسجانينا أنه حتى الحبس لن يمنعنا من تحقيق أحلامنا أو يمنع نجاحنا. وسيظل التعليم، كما هو الحال دائماً، واحداً من أكثر أسلحتنا شراسة.
مع اقتراب إطلاق سراحي، شعرت بالقلق الشديد. أصبح القلق منهِكاً لدرجة أنني كنت أكافح حتى لمغادرة زنزانتي. بقيت أحدق في ساعتي-التي تعطيها الكيان الصهيوني لجميع السجناء/السجينات- وأعد الساعات والدقائق المتبقية حتى أصل إلى المنزل. أصبحت مهووسة بمتابعة الوقت حتى أن الفتيات أخذن الساعة وأخفينها عني. لكن أفكاري ومخاوفي حول كيفية إعادة الاندماج في حياتي السابقة لم تتوقف. كنت أتوتر كلما فكرت في كيفية التحدث إلى عائلتي وأصدقائي. لقد انفصلنا بشكل قطعي لمدة ثمانية أشهر، لم تكن هناك أي وسيلة تواصل. لقد أصبحت شخصاً مختلفاً تماماً خلال ذلك الوقت، وكنت أخشى أنهم لن يستطيعوا التواصل معي بنفس الطريقة القديمة. تصورت أنه سيتعين علينا التعرف على بعضنا البعض من البداية، كان شعوراً شاقاً.
أثناء فترة حبسي، مرات كثيرة كنت اتخيل أنني أحمل بعض الشيكلات في يدي وأذهب إلى مقهى لشراء قهوة مثلجة. كان مجرد الحلم بشيء بسيط -مثل الإحساس بملمس العملات المعدنية في يدي- مثير. جعلني ذلك اعي قيمة العديد من الأشياء التي نعتبر وجودها أمراً مفرغاً منه حتى تُنتزع منا فجأة. تعهدت بعدم إغفال نعمي الكثيرة مرة أخرى. ومع ذلك، ومع اقتراب عودتي إلى المنزل، فإن فكرة المشاركة مرة أخرى في الأعمال المعتادة مثل الذهاب إلى المتجر أو حتى مجرد المشي في الشارع أخافتني. لقد مر وقت طويل منذ أن قمت بهذا او ذاك، أو حتى منذ رأيت شارعاً أو سيارة. هل سأكون قادرة على تنفيذ مثل هذه المهام البسيطة؟
مع مرور الأيام، بدأت أشعر بالذنب بشأن ترك عائلتي التي كونتها في السجن. كن يعربن باستمرار عن مدى حماسهن لخروجي ولعودتي إلى المنزل حتى أنهن أعددن قائمة بجميع الأشياء المطلوب مني أكلها نيابة عنهن: المثلجات وسندويشات الشاورما والبيتزا وما إلى ذلك. حاولت أن استمتع بوقتي معهن قدر الإمكان، مع العلم أنني سأفتقدهن بشدة، وأنه حتى يتم إطلاق سراحهن أيضاً، لن يكون لدينا أي طريقة للتواصل. استباقاً للشوق الحتمي لبعضنا البعض، والذي سنعانيه بالتأكيد، كتبنا رسائل وقصص تسلط الضوء على الذكريات المفضلة التي عشناها معاً. رسمنا صوراً وتهادينا مجوهرات صنعناها من مواد الصليب الأحمر. استخدمت دفتر الملاحظات المخملي الذي كنت قد خيطته بأكياس الورق المقوى وخيوط أكياس البطاطس لأصنع مثل كتاب سنوي ومرَّرته لكل فتاة وامرأة في زنزانتنا لتكتب لي رسالة شخصية. ولا يزال هذا الدفتر من أعز ممتلكاتي.
“تُشكّلُ النساءُ نصفَ مُجتمعاتِنا، وهُنَّ اللواتي تُربّين جُملَةَ هذا المجتمَع.”

بالكاد استطعت النوم في الليلة التي سبقت إطلاق سراحي. مزيج من المشاعر ظلت تتصارع في ذهني، من الحماس للعودة إلى عائلتي حتى الشعور بالذنب لأنني اترك تلك الفتيات ورائي. إضافة إلى ذلك، في المرتين اللتين تمكن فيهما والدي من زيارتنا في السجن، أبلغني أن قصتي قد أثارت زوبعة دولية وأنه يجب عليّ أن أستعد لموجة من الاهتمام من قِبل وسائل الإعلام بمجرد إطلاق سراحي. لهذا السبب، قبل يومين، طلبت توجيهات خالدة حول كيفية التوجه للصحافة عند خروجي. أردت التأكد من أنني سأكون قادرة على نقل رسائل زميلاتي السجينات بشكل صحيح إلى الإعلام. دربتني خالدة على كيفية ترتيب أفكاري في نقاط حوار موجزة. وعلى الرغم من نصائحها المفيدة جداً، لم تكن هناك طريقة تمكنني من الاستعداد بشكل كاف لما واجهته لاحقاً.
كنت أتوقع أن يكون لديَّ وقت في الصباح لأقول وداعاً ولأحصل على توديع مناسب، حيث عادة يتم إرسال السجناء/السجينات إلى منازلهم بعد الظهر. لكن قبل وقت قصير من الساعة الخامسة والنصف صباحاً، جاء حارس إلى زنزانتي وقال: “عهد، ارتدي ملابسك”. ارتديت الزي الذي أرسلته عائلتي لأعود به إلى المنزل ووقفت مع باقي الفتيات في طابور العد. بمجرد انتهاء العد، أخبرني الحارس أن الوقت قد حان للذهاب. التفت إلى الفتيات اللواتي بكين. ونظرن إليّ كما لو كانت المرة الأخيرة التي نرى فيها بعضنا البعض. فلا يزال أمام بعضهن أكثر من عِقد من الزمان لتكملة العقوبة. لم يتحمل قلبي أن أتركهن هكذا، لكنني حبست دموعي وعانقتهن واحدة تلو الأخرى. أوصينني ان أبقى قوية وقلن إنهن تضعن ثقتهن فيّ لأكون صوتهن في الخارج.
غادرت زنزانتي ووقفت في الممر الضيق ما بين صفين من الزنازين. كانت جميع أبواب الزنازين مغلقة، لكن النساء والفتيات دسسن أيديهن من خلال الفتحات الضيقة، نفس الشقوق التي كانت تُقيَد أيدينا من خلالها قبل الذهاب إلى المحكمة. مشيت بجانب كل باب وأمسكت بأيديهن، قلنا وداعاً دون أن نرى بعضنا البعض. كانت أمي معي، وودعت هي أيضاً النساء الأخريات بنفس الطريقة. عندما وصلنا إلى زنزانة خالتو ياسمين وخالدة، طلبَت خالتو ياسمين من الحارس فتح الباب. امتثل الحارس، ودخلْت إليهما للمرة الأخيرة. وبينما كنت أحتضنهما معاً، تفكرت في الدروس التي علمتاني إياها خلال الأشهر القليلة الماضية. لم تكن دروس القانون الدولي وحدها هي التي اتسعت معها آفاقي. لكن اقتداءً بهما، تعلمت أيضاً كيف أكون امرأة قوية تدافع عن نفسها وتتكلم بالحق في وجه السلطة. لقد ساعدتاني على فهم الدور الحاسم الذي تلعبه المرأة في مجتمعنا وفي نضالنا من أجل الحرية. تشكل النساء نصف مجتمعنا، وهن اللواتي يربين جملة هذا المجتمع. علينا أن نضمن أنهن قويات ومسلحات بالتعليم والوعي السياسي من أجل تنشئة الجيل القادم الذي سيحرر فلسطين.
بكت كل من خالدة وخالتو ياسمين وهما تحتضناني أنا وأمي.
“ستبقين صوتنا ووكيلتنا”، قالت لي خالدة. “لا تستسلمي لأي شخص، ولا تتركي أي شخص يثنيكِ عن تحقيق أهدافك. نحن نعرف من أنتِ وما أنت قادرة عليه”.
“أعدك بأنني سأحاول أن أجعلك فخورة”، أجبتها. وكنت أعني ما اقول.
“هيا. حان الوقت للذهاب”، نادانا الحارس.
على الرغم من كل الصعوبات التي واجهتها خلال تلك الأشهر الثمانية، يظل هذا الوداع الأخير من أكثر الذكريات إيلاماً خلال فترة وجودي في السجن. لم يكن الأمر مجرد أنني سأفتقد تلك الفتيات والسيدات اللواتي أصبحن عائلتي؛ لكن لعلمي بأن الدولة تعمل كل يوم على سحقهن، وإحباطهن، وكسر معنوياتهن. وبدلاً من أن أكون حليفتهن في المعركة وتحت مظلة رعايتنا الجماعية لبعضنا البعض وفرحنا المشترك ومقاومتنا المشتركة، كنت أتركهن وأمضي نحو حريتي الخاصة. كل وداع بدا وكأنه خسارة فادحة، لم أتعاف منها حتى هذا اليوم.
أخذنا الحارس إلى زنزانة جديدة، حيث اضطررنا إلى الانتظار حتى يحين الوقت لمغادرة سجن هشارون -وكنا نأمل أن يكون ذلك- للمرة الأخيرة. وبمجرد أن حان الوقت، حاول الحراس أخذ جميع متعلقاتي الشخصية، بما في ذلك جميع الرسائل والقطع الفنية والمجوهرات التي أهدتني إياها الفتيات. جلست أنا وأمي على الأرض احتجاجاً. قلنا لهم إن بإمكانهم إعادتنا إلى زنازيننا، لأننا لا لن نغادر بدون هذه الأشياء. كنت أعتز بتلك التذكارات الشاهدة على فترة وجودي في السجن – لقد أصبحَت قطعاً عاطفية ثمينة تتحدث عن فصل مهم من قصة حياتي، فصل غيرني إلى الأبد. بالإضافة إلى ذلك، كنت أحمل رسائل كتبتها الفتيات إلى ذويهن، وكنت قد وعدْت بتسليمها. بعض الفتيات لم يزرهن آباؤهن منذ أكثر من أربعة أشهر، ورفضت أن أخذلهن. عندما رأى الحراس أننا لم نهدأ، وافقوا أخيراً على السماح لنا بحمل متعلقاتنا معنا.
عندما يتم إطلاق سراح السجناء/السجينات الفلسطينيين، عادة ما تقوم السلطات الإسرائيلية بإنزالهم عند نقطة تفتيش، حيث تنتظر عائلاتهم بحماس لاستقبالهم وإعادتهم إلى ديارهم. ولأسابيع، كنت أتخيلني في السيارة المتجهة للمنزل في موكب النصر، أمد جسدي خارج النافذة وأرفع أصابعي بعلامة السلام بينما أستنشق ملئ صدري الهواء النقي الذي حُرمت منه لفترة طويلة. توقعت أن يتم إنزالنا عند نقطة تفتيش جبارة القريبة من السجن، حيث يتم إنزال معظم السجناء المفرج عنهم من هشارون؛ حتى أن السلطات الإسرائيلية أبلغت والدي بأن هذا هو المكان الذي سنلتقي فيه. لكن بعد فترة وجيزة من إعطائه هذه المعلومات، غيروا خططهم وأخبروه أنه سيتم إنزالنا عند نقطة تفتيش رانتيس، على بعد حوالي ساعة ونصف من جبارة، ولكن أقرب إلى القرية. ما تلا ذلك كان عدة ساعات من الفوضى والمعلومات المتضاربة التي انتهت بإرسال والدي والعديد من أفراد عائلتي والعشرات من طواقم الأخبار في مطاردة كالبط البري، يتسابقون ذهابا وإيابا بين نقطتي التفتيش.
في هذه الأثناء، كنا أنا وأمي في السيارة العسكرية مقيدات من معصمينا وكاحلينا وأعيننا معصوبة. لم يُسمح لنا بالتحدث مع بعضنا البعض، ولم يكن لدينا أي فكرة عن موقعنا. توقفت السيارة الجيب أخيرا عن الحركة، وطلب مني الجنود الوقوف. وضعوني وظهري إلى الباب، وخلعوا عصابة عيني، وبدأوا في إزالة الأصفاد. كنت أسمع ضجة خارج السيارة، والناس يصرخون. أدارني الجنود في اتجاه الباب وفتحوه. خرجت من الجيب، وكان أول شخص رأيته – بخلاف الجنود النظاميين المحيطين بالسيارة- هو والدي. ركضت لمعانقته، متحمسة للاجتماع به أخيرا. أدركت حينها أننا لم نكن عند نقطة تفتيش على الإطلاق، بل على مدخل النبي صالح. لأسباب لا تزال غير واضحة، قرر الجنود إنزالنا في القرية. لن أحصل على موكب الفرح الذي تخيلته اذاً، لكنني كنت سعيدة بالعودة أخيرا إلى المنزل.
بالإضافة إلى أصدقائنا ونشطائنا وعدد لا يحصى من مندوبي ومندوبات المجلات، أتى جميع من في القرية لمنحنا استقبال الأبطال. لوَح أصدقاؤنا وعائلتنا بالعلم الفلسطيني ورفعوا ملصقات عليها صورتي. ووقف والدي يلف كوفية حول كتفي.

ما حدث بعد ذلك كان مشوشاً. أتذكر ضجيج الصحفيين المحيطين بنا، والكاميرات تشير إلى وجهي في كل مكان أنظر إليه. صاح الناس وطلبوا منهم التراجع من أجل إعطائي وأقاربي المساحة اللازمة للاستمتاع بلم الشمل، لكنهم ظلوا يقتربون منا، كل مصور حريص على الحصول على أفضل صورة ممكنة. في تلك اللحظة بدأت حقاً في فهم مدى ضخامة قصتي وكيف – من الآن فصاعداً – سيتعين عليّ أن أخطو إلى دور أكبر بكثير مما كنت أتخيل.